
المراد
- هنا - باللياقة النفسية تحصيل صفات وفضائل معينة تعين صاحبها على مواجهة الحياة
وخوض غمارها بنجاح أكبر ممن لا يتحلى بتلك الصفات.
ويلاحظ
أن اللياقتين: الروحية والنفسية فيهما بعض التداخل، وهذا أمر طبيعي؛ لأنَّ الإنسان
كلٌّ واحد، لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء بعضها منفصل عن بعض.
ويدور
حديثنا عن اللياقة النفسية حول ثلاثة محاور
الأول:
فضائل نعمل على اكتسابها ورذائل نعمل على اجتنابها.
والثاني:
القوانين النفسية السبعة وكيف نستفيد منها.
والثالث:
نصائح للتخلص من القلق.
فضائل
ورذائل (مستفاد من كتاب: أدب
الدنيا والدين، للماوردي)
وقد
وقع الاختيار على اثنتي عشرة فضيلة وصفة نرجو أن يحقق التحلي بالمحمود منها،
والتخلي عن المذموم درجة عالية من اللياقة النفسية بإذن الله، وكما سبق أن أشرنا،
فهذه الصفات تكتسب بالتدريج، وبالرياضة والممارسة ولا يمكن تحصيلها بين يوم وليلة.
(1)
العقل والهوى
العقل:
هو الملكة التي تعقل صاحبها وتمنعه وترده عن الخطأ والقبيح. وفي الحكمة: (ما اكتسب
المرء مثل عقل يهديه إلى هدى، أو يرده عن ردى).
والهوى:
ميل النفس إلى االشهوة. وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه، فالهوي: السقوط من علو
إلى سفل. ومن الأقوال المأثورة في العقل والهوى:
-
أصل الرجل عقله، وحَسَبُه دينه.
-
العقل أفضل مرجو، والجهل أنكى عدو.
-
صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله.
-
الهوى إلهُ يُعبد من دون الله : {أَفَرَأَيْتَ مَنِ
اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ
سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن
بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23)} [الجاثية: ٢٣]
-
طاعة الهوى داء، وعصيانه دواء.
والكلام
في هذا الموضوع يطول، وفيما ذكر غنيةٌ للمستغني، والمتأمل يدرك أن أساس تحصيل
اللياقة النفسية: اتباع العقل، ومخالفة
الهوى، والله تعالى أعلم.
(2)
محاسبة النفس
محاسبة
النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر منه من أفعال في نهاره، فإن كان محمودا
أمضاه وأتبعه بما شاكله، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن، وانتهى عن مثله في
المستقبل. والدليل على محاسبة النفس من القرآن الكريم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)} [الحشر: ٨١ ].
ومن
الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: (الكيِّس من
دانَ نفسه، وعَمِل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسَه هواها، وتمنَّى على الله
الأماني). [رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن].
الكيس
: العاقل المتبصر في الأمور، الناظر في العواقب.
ومعنى
قوله: (من دان نفسه): حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة.
ويروى
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا
للعرض الأكبر، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية»
[مصنف ابن أبي شيبة].
وإنما
يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. قال ابن العربي - رحمه
الله - : (كان أشياخنا يحاسبون أنفسهم على ما يتكلمون به وما يفعلونه، ويقيدونه في
دفتر، فإذا كان بعد العشاء حاسبوا أنفسهم، وأحضروا دفترهم ونظروا فيما صدر منهم من
قول أو عمل، وقابلوا كلا بما يستحق، إن استحق استغفارا استغفروا، أو التوبة تابوا،
أو شكرا شكروا، ثم ينامون، فزدنا عليهم في هذا الباب الخواطر، فكنا نقيد ما نحدث
به نفوسنا، ونهم به، ونحاسبها عليه) [انظر: فيض القدير (
٥ / ٦٧ )].
(
٣ ) الصدق والكذب
الصدق
هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو
عليه، والصدق من أعظم الفضائل، كما أن الكذب من أكبر الرذائل. ولا يمكن لكذاب أن
يتحلى باللياقة النفسية مهما كان دينه.
وفيما
يلي عدد قليل من الأحاديث الشريفة تحث على الصدق، وتنهى عن الكذب:
عن
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق
حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا»
[متفق عليه].
وعن
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما –
أن النبي ﷺ
قال: «أربع
من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى
يَدَعَها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» [متفق
عليه].
(4)
حُسْنُ الخلق:
وحسن
الخلق أن يكون الإنسان سَلِسا مُنقادًا، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب
الكلمة. قال رسول الله ﷺ:
«إن المؤمن ليُدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»
[رواه أبو داود]، وقال عليه الصلاة والسلام: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لأهله»
[رواه الترمذي].
وقال:
«ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق
ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة»
[رواه الترمذي]. وقال: «إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسِنَكم أخلاقا
... » [رواه الترمذي].
وإذا
حسنت أخلاق المرء كثر أصدقاؤه، وقل أعداؤه، فتسهلت عليه الأمور الصعاب، ولانت له
القلوب الغضاب. والحسن الخلق هو من نفسه
في راحة، والناس منه في سلامة، أما السيئ الخلق فالناس منه في بلاء، وهو من نفسه
في عناء.
(5)
الحياء:
الحياء
خلق يدعو صاحبه إلى ترك الأعمال القبيحة ويمنعه من التقصير في أداء الحقوق.
وهو
ثلاثة أنواع:
أ
- حياء من الله تعالى: يدعو إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه.
ب
- وحياء من الناس يكون بكف الأذى، وترك المجاهرة بالأمور القبيحة.
ج
- وحياء من النفس ويكون بالعفة وصيانة الخلوات.
قال
بعض الأدباء: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر.
قال
رسول الله ﷺ: «... الحياء من الإيمان» [رواه
مسلم]
وقال: «الحياء لا يأتي إلا بخير» [متفق
عليه]
(6)
الحلم والغضب:
الحلم:
ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وهو : كَظم الغيظ. قال تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ
يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)}
[آل عمران: ١٣٣، ١٣٤ ] .
وعن
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ
لأشج عبد القيس: «إن فيك
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة»
[رواه مسلم]، والأناة: التثبت وترك العجلة.
وعن
عائشة رضي الله عنها - أن النبي ﷺ
قال: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف،
وما لا يعطي على ما سواه»
[رواه مسلم].
وعن
أبي هريرة الله أن رجلا قال للنبي ﷺ:
أوصني، قال: «لا تغضب»
فردد مرارا، قال: «لا تغضب».[رواه البخاري] وقديما قيل: إياك وعزة الغضب؛ فإنها تفضي
إلى ذل الاعتذار.
(7)
التواضع (مجانبة الكبر والإعجاب):
قال
رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر»[رواه مسلم].
التكبر
على الآخرين، والإعجاب بالنفس من الأخلاق الذميمة التي تكره الناس بصاحبها؛ لأن الناس
لا يحبون من يرفع نفسه عليهم.
ومن
أسباب الكبر المركز الاجتماعي العالي، والغنى وقلة مخالطة المتكبر لمن هم مثله أو
خير منه؛ فالغني إذا خالط من هو أغنى منه، والرئيس من هو أعلى منه، والعالم من هو
أعلم منه، تَصْغر لديه نفسه.
روي
أن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جمع الناس، وصعد المنبر، فحمد الله وأثنى
عليه ثم قال: أيها الناس: كنت أرعى أغناما لخالات لي من بني مخزوم، وكانت أجرتي
القبضة من التمر والزبيب. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لقد قصرت بنفسك يا أمير
المؤمنين. فقال عمر: إني خلوت بنفسي، فقالت: أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟
فأردت أن أعرفها قدرها.
ومن
أسباب الإعجاب كثرة مدح المتقربين، وإطراء المتملقين، الذين جعلوا النفاق عادة
ومكسبا. وفي أمثالهم قال رسول الله ﷺ:
«إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب».
[رواه مسلم]
قال
أحد الحكماء: عجبت لمن يمدح بما ليس فيه كيف يفرح، ولمن وصف بعيب فيه كيف يغضب!
والعقلاء
- في كل زمان ومكان - يسترشدون بإخوان الصدق الذين هم مرايا المحاسن والعيوب،
ويسألونهم عن أخطائهم حتى يصلحوها، وقد ورد في الحديث الشريف: «المؤمن مرآة المؤمن» [رواه
أبو داود]. كما
روي عن عمر بن الخطاب له قوله: «رحم الله امرأً
أهدى إليَّ عيوبي».
(8)
الحسد والمنافسة:
الحسد:
تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. قال الله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن
فَضْلِهِ} [النساء : ٥٤ ] . والحسد خلق ذميم مع إضراره
بالبدن وإفساده للدين، حتى لقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من شره فقال: {وَمن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} [ الفلق : ٥].
وعن
الزبير بن العوام الله أن رسول الله ﷺ
قال: «دَبَّ
إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، أما إني لا أقول: تحلق الشعر،
ولكن تحلق الدين». [رواه الترمذي]
وعند
أبي داود: «إياكم
والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»،
أو قال: «العشب»
وحقيقة
الحسد الحزن على الخير الذي يناله الناس وفرق بين الحسد والمنافسة في الخير؛ لأن المنافسة
طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال الضرر عليهم، والحسد مصروف إلى الضرر؛ فالمنافسة
فضيلة، والحسد رذيلة: {وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُونَ} [ المطففين: ٢٦].
وقد
قيل: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. فلا بد من اجتناب الحسد، والتحلي بروح المنافسة
لتحصيل اللياقة النفسية.
(9)
الصبر والجزع
إن
من علامات التوفيق والسعادة، ومن أهم أركان اللياقة النفسية: الصبر وعدم الجزع.
وقد أمرنا الله تعالى بالصبر فقال: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (200)} آل عمران. وبيَّن الأجر العظيم الذي يناله الصابرون
فقال: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم
بِغَيْرِ حِسَابٍ (10)} الزمر : ١٠.
والصبر
أنواع:
منه
الصبر على الامتثال لما أمر الله تعالى به، والانتهاء عما نهى عنه. ومنه الصبر على
ما نزل من مكروه، أو حل من أمر مخوف. ومنه الصبر على ما فات
إدراكه من رغبة مرجوة، أو مسرة مأمولة: فإن الصبر عنها يعقب السلو منها.
أما
الجزع فلا فائدة فيه، فإن من لم يصبر طائعا راضيا، صبر كارها آثما.
قال
سيدنا علي – رضي الله عنه - للأشعث
بن قيس: إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت
مأزور.
(10)
الاستشارة
الحكيم
من الناس لا يبرم أمرًا مهما إلا بمشاورة ذي الرأي الناصح؛ فإن الله تعالى أمر
بمشاورة نبيه مع أنه سبحانه تكفَّل بإرشاده، ووعد بتأييده، فقال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]. وذلك
ليستنَّ به المسلمون، فهو غني بالله تعالى عن مُشاورتهم.
ومن
الحكم التي قيلت في أهمية الاستشارة
-
نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد.
-
من أعجب برأيه لم يشاور، ومن استبد برأيه كان من الصواب بعيدا.
-
من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء؛ فالرأي
الواحد ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل.
ومن
صفات المستشار أن يكون صاحب خبرة فيما يستشار فيه، وأن يكون ناصحًا وَدُودًا، ذا
دين وتقى وألا يكون له في الأمر المستشار غرض ولا مصلحة.
(11)
كتمان السر:
أوصى
الحكماء منذ القدم بأن يكتم الإنسان أسراره ولهم في ذلك أقوال مأثورة كثيرة، أختار
بعضها، وأدعو إلى تأملها، ورياضة النفس عليها لتطبيقها، منها:
-
"استعينوا
على إنجاح حوائجكم بالكتمان". [رواه
الطبراني وأبو نعيم بسند ضعيف]
- سرك أسيرك، فإن
تكلمت به صرت أسيره.
-
كم من إظهار سر أراق دم صاحبه، ومنعه من نيل مطالبه.
والذي
يفشي سره إما ساذج لا خبرة له بطباع الناس، وإما ضيق الصدر، قليل الصبر، قال
الشاعر:
إذا المرء أفشى سره
بلسانه
** ولام عليه غيره
فهو أحمق
إذا ضاق صدر المرء عن
سر نفسه
** فصدر الذي يُستودع
السر أضيق
ومن
الأسرار ما يحتاج الإنسان إلى أن يستشير فيه حكيما ناصحا، ولا يجد إلى كتمانه
سبيلا، عندئذ عليه أن يبذل جهده في اختيار الأمين، وليعلم أنه ليس كل من كان أمينا
على الأموال فهو أمين على الأسرار؛ فالإنسان قد يذيع سر نفسه بلسانه، ويبخل
باليسير من ماله، ومن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل، ودين، وكتوما بطبعه، وهذا
نادر بين الناس.
(12)
الفأل والطيرة:
الطيرة
والتطير: التشاؤم بالشيء. والفأل والتفاؤل: توقع الخير. وكان
رسول الله ﷺ "لا يتطير من شيء" [رواه أبو داود]
قال
عليه الصلاة والسلام: "الطيرة من الشرك".
قال عبد الله ابن مسعود - راوي الحديث - وما منا إلا ويعتريه التطير، ولكن الله
يذهبه بالتوكل" [رواه أبو داود].
وقد
ذكرت الطيرة عند رسول الله ﷺ
فقال: "أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى
أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت،
ولا حول ولا قوة إلا بك". [رواه أبو داود].
إن
التطير مضر بالرأي، مفسد للتدبير، ومن ظنَّ أن نباح كلب أو نعيب غراب يردّ من قضاء
الله شيئًا فقد جهل. وأما التفاؤل ففيه انشراح الصدر، وتقوية العزم، وهو باعث على الجد،
ومعين على الظفر.
القوانين
النفسية السبعة:
استخلص
بعض علماء النفس المختصين بالكشف عن المواهب الفردية وتنميتها [منهم برايان تريسي في كتابه علم نفس النجاح، وهذه القوانين
مستفادة منه]، وتعريف الفرد على الطاقات الكامنة فيه وكيفية استغلالها
استخلصوا قوانين نفسية إن صحت التسمية [في هذه التسمية
شيء من التساهل؛ لأن هذه (القوانين) ليست منضبطة دقيقة كقوانين الفيزياء أو
الرياضيات] يمكن للمرء إذا ما طبقها أن يحقق ما يطمح إليه بتوفيق الله.
ومن
هذه القوانين:
أولا:
قانون الضبط والتحكم
يقول
هذا القانون: "إن مقدار ما نملكه من ضبط وتوجيه لحياتنا يحدد مقدار صحتنا
النفسية، وعدم شعورنا بالاضطراب.
المطلوب
منا أن نشعر أنّ المقود بيدنا لا بيد غيرنا، لكن أكثر الناس لا يأخذون بالأسباب
وينتظرون أن يحدث لهم ما يشتهون".
والمراد
أن تشعر أنك مسؤول عن تصرفاتك وتملك حرية الاختيار في القضايا التي تخضع عادة
لسيطرة الإنسان، لا في الأمور التي هي خارجة عن طاقته.
وفي
الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مثال عن المراد
من هذه النقطة؛ فهو عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»،
أي: ليس القوي حقا هو الذي يصارع الرجال ويغلبهم، إنما هو الذي يضبط نفسه ويسيطر على
أعصابه ويتحكم فيها. وهذا مثال واحد على قانون الضبط والتحكم.
إن
من أهم الاسباب المؤدية إلى تخلف بعض المسلمين –
في نظري - منطق الجبر الذي يحاكمون به الأشياء؛ فهم يتركون العمل اعتمادا على فهم
خاطئ للقضاء والقدر، والصواب أن يعملوا جهدهم، ويبذلوا ما في وسعهم، ثم يتركوا
الأمر لله سبحانه.
والقرآن
الكريم حافل بما يدل على هذا المعنى من مثل قوله تعالى : { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فَسَنُيَسِّرُهُ لليُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَبَ
بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}. الليل 5 - 10، فالتيسير لليسرى
نتيجة سببها العطاء والتقوى والتصديق، والتيسير للعسرى نتيجة سببها البخل والاستغناء
والتكذيب.
كذلك
السنة حافلة بما يؤكد هذا المعنى؛ فقد ورد أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام:
هل يعقل ناقته (أي: يربطها) ويتوكل، أم يطلقها ويتوكل؟ فأجابه: "اعقلها وتوكل" [رواه الترمذي]؛ لأنَّ
عقلها لا ينافي التوكل.
إن
الذين يريدون النجاح عليهم أن يفهموا قانون السببية فهما عميقا ويطبقوه في حياتهم
اليومية، كل ما يحدث في الكون له سبب يؤدي إلى حدوثه، بعض هذه الأسباب في مقدور
الإنسان أن يتدخل فيها أو يؤثر، وهي محل بحثنا، وبعضها خارج عن دائرة قدرته، وإن
كان من اهتمامه، وهذه لا شأن لنا فيها.
وهذا
ما قصه علينا القرآن الكريم في حديثه عن ذي القرنين إذ قال: { إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن
كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا . فَأَتْبَعَ سَبَبًا} [الكهف: ٨٤ ، ٨٥]. وفي قراءة: «فَاتَّبَعَ
سَبَبًا». أي: أن الله تعالى هيَّأ له
الأسباب التي توصله إلى مقاصده من العلم والقدرة، والأدوات، فلم يقعد عن الأخذ
بها؛ بل اتبعها وحقق بفضل الله ما حقق.
إن
الناس جميعًا متفقون على أن: من جد وجد، ومن زرع حصد. قد يدرس الطالب ويذاكر ثم
يرسب، وقد يزرع الفلاح ثم يهلك زرعه. نعم، في هذه الحالة لا يُلام أحد منهما: لأنهما لم يقصرا؛ بل أخذا
بالأسباب فلم تؤد إلى نتائجها لأمر يريده الله، وهنا يأتي مقام الرضا بالقضاء
والقدر.
ثانيا:
قانون التوقع
القانون
الثاني من القوانين النفسية هو قانون التوقع. يقول هذا القانون: "إن توقع
الشيء يؤدي إلى حدوثه، فإذا توقع المرء توقعا قويا أنه سيكون ناجحًا، فإن هذا
التوقع يسهم إسهاما كبيرا في نجاحه. فهو يُحدِّث نفسه بهذا النجاح، ويفكر فيه
دائما، ويحدث خلصاءه عنه مما يجعل فكرة النجاح تتمكن في نفسه وتوجه سلوكه وكذلك
توقع الإخفاق يوجه سلوك أصحابه نحوه. ولا فرق بين أن يكون التوقع مبنيا على أسس
صحيحة أو خاطئة في الأصل.
وللبرهنة
على هذا أجريت التجربة الآتية: [انظر
فن التفوق والنجاح للمؤلف ( ص ۲۰ )].
قال
مدير إحدى المدارس لثلاثة من مدرسيه بما أنكم أفضل ثلاثة مدرسين عندي فقد اخترت
لكل واحد منكم ثلاثين طالبا من أنبه وأذكى طلاب المدرسة لتدرسوهم في صفوف خاصة،
ولكن لا تخبروا الطلاب ولا أهاليهم بهذا، وأبقوا الأمر سرا حتى لا تفسد التجربة.
درسوهم بشكل عادي واستخدموا معهم المنهج العادي نفسه، ولكننا نتوقع أن تكون
نتائجهم جيدة وفعلا كانت النتائج رائعة، وقال المدرسون إنهم وجدوا الطلاب يتجاوبون
ويفهمون بشكل لم يعتادوا عليه.
وأخبر
المدير المدرسين بأن الموضوع لم يكن إلا تجربة وأن الطلاب عاديون جرى اختيار
أسمائهم عشوائيا. فقال المدرسون: إذن السبب فينا
نحن؛ لأننا أفضل ثلاثة مدرسين عندك !
هنا قال المدير: يؤسفني أن أعلمكم أن أسماءكم أنتم أيضًا قد
اختيرت بالقرعة فاندهش المعلمون الثلاثة. وبهذا يستدل من يقول بهذا القانون على أن
التوقعات هي التي صنعت النتيجة، حتى ولو كانت المعلومات في الأصل خاطئة.
إن ما يتوقعه الآباء والأمهات من أولادهم له أكبر الأثر في
توجيه سلوكهم. وإن ما يتوقعه منا الآخرون يتحكم فيما نعمله بشرط أن يكون توقعهم
قويا واضحا. إذا توقعوا التفوق والتألق فسوف يكون ذلك بإذن الله، وإذا توقعوا
التخلف والإخفاق فسوف يكون ذلك أيضًا.
فليتنبه لهذا الأمر، المهم الآباء والأمهات والمعلمون
والمعلمات. ومع ذلك فأهم شخص في تحقيق توقعات المرء هو المرء نفسه!
ثالثا: قانون الجاذبية
القانون الثالث من القوانين النفسية - وله بعض صلة بالقانون
الثاني - هو قانون الجاذبية.
يقول هذا القانون: "الإنسان كالمغناطيس، يجذب إليه
الأشخاص الذين ينسجمون مع طريقة تفكيره. فإذا أراد أن يغير الظروف المحيطة به،
فليغير طريقة تفكيره".
فالمتفائل يجذب إليه الأشخاص الذين يعينونه على تحقيق ما
يصبو إليه، والمتشائم عكسه، وهذا ليس اكتشافا جديدا، فمنذ القديم قيل: إنّ الطيور
على أشكالها تقع. وقيل : وشبه الشيء منجذب إليه.
رابعا: قانون الأفكار (قانون التعويض):
إن العقل الواعي يستطيع أن يحتضن فكرة واحدة فقط في وقت
واحد، سواء أكانت هذه الفكرة سلبية أم إيجابية؛ لذلك يجب علينا أن نطرد أي فكرة
سلبية تسكن وعينا، ونضع عوضا عنها فكرة إيجابية. إذا أردنا أن نكون مواقف إيجابية
في حياتنا، فعلينا أن نفكر باستمرار بالأشياء والأحداث والمواقف الإيجابية ونبتعد
عن كل ما هو سلبي.
إن العقل كالحديقة، إما أن تنمو فيها الأزهار الجميلة وإما
الأعشاب الضارة. لكننا ما لم نزرع - عن قصد واختيار - الأفكار النافعة في عقولنا،
فإن الأفكار السلبية الضارة ستنمو فيه؛ فالحشائش والأعشاب الضارة تنمو وحدها، ولا
تحتاج إلى عناية ورعاية لتشب وتكبر. وكذلك المخاوف والأفكار الضارة تغزو العقل
وتنمو فيه، ما لم نقم - عن وعي وعمد - بزراعة الأفكار الإيجابية النافعة بدلا منها.
إن الفكرة الإيجابية إذا دخلت وعي المرء تطرد الفكرة السلبية
التي تقابلها. والعقل لا يقبل الفراغ، إذا لم نملأه بالأفكار التي تفتح أمامنا
آفاق التقدم والانطلاق، فسوف يمتلئ بالأفكار المؤذية التي تحول بيننا وبين النمو
والتقدم.
وإلى هذا تشير الحكمة القائلة: إذا لم تُشغل نفسك بما ينفعك
شغَلَتْكَ بما يؤذيك.
ومما يحسن إيراده في هذا المقام كلام نفيس للإمام ابن القيم
- رحمه الله - يقول: الفوائد: ( ص ٢٥٠)
"وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي
لا تسكن، ولا بد لها من شيء تطحنه؛ فإن وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو
حصى طحنته؛ فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في
الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط؛ بل لا بد لها من شيء يوضع فيها؛ فمن الناس من
تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبنا ونحو
ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه".
خامسا: قانون التكرار
إن قدرتنا العملية كالقدرة على لعب التنس، أو الطباعة على
الآلة الكاتبة، أو السباحة مثلا تبدأ بتعلم المهارة المطلوبة ثم التدرب عليها
وتكرارها حتى تصبح عادة. كذلك الأمر بالنسبة للعادات العقلية، فإذا أردنا إحلال عادة
عقلية إيجابية محل أخرى سلبية، فعلينا أن نفكر بها مرات حتى تصبح عادة عندنا.
إن الناجحين لا يفكرون - عندما ينهضون من أسرتهم في الصباح
- أنهم سيكونون إيجابيين. لقد أصبح التفكير الإيجابي عادة عندهم.. لقد تعودوا على
التفاؤل، وعلى توقع الأفضل في كل موقف حياتي يمر بهم.
إنهم يفعلون هذا بشكل تلقائي دون أن يفكروا فيه؛ لأنه أصبح
عادة عندهم. إن مستقبلنا يعتمد -بعد الله- على العادات العقلية الصحيحة التي
كوناها عن عمد ووعي، وصدق من قال: كون لنفسك عادات صحيحة ثم أسلم لها قيادك ..
سادسا: قانون الاسترخاء
يقول هذا القانون: "إن بذل الجهد في الأعمال العقلية
يهزم نفسه، بخلاف الأعمال الحسية الجسمية"، فنحن إذا أردنا أن نقطع خشبة -
مثلا - أو ندق مسمارا، فكلما كان الجهد أقوى كان قطع الخشبة أو دخول المسمار أسرع.
أما في الأعمال العقلية فما يحصل هو العكس تماما، وإذا حاولنا تحقيق ما نصبو إليه
في أقصر من الوقت الذي نحتاجه، فسوف نؤذي أنفسنا؛ لأن (من تعجَّل الشيءَ قبل أوانه
عُوقب بحرمانه)، فالمطلوب منا - إذن - أن نعتقد بهدوء واسترخاء أن ما نحاول الوصول
إليه سيتحقق - بعون الله - إذا صبرنا وانتظرنا.
سابعا: قانون التخلّي والتحلي ( كيف نترك العادات السلبية
ونكتسب العادات الإيجابية)
إن كل فرد منا يتغير باستمرار. لا يوجد استقرار كامل في الشخصية
الإنسانية. إذا وعينا هذه الحقيقة أمكننا أن نوجه التغيير إلى ما هو نافع ومفيد؛
فيعمل معنا لا ضدنا.
إن اكتساب عادة (عقلية أو ذهنية أو نفسية) جديدة ليس أمرا
صعبا، فهو يتطلب - كما يقول أكثر المختصين - ( ۲۱ ) يوما. في هذه الأيام الإحدى
والعشرين علينا أن نقوم بأربعة أمور:
۱ - نفكر
٢ - ونتحدث
3 - ونتصرف وفق ما تمليه علينا العادات الجديدة المطلوبة.
٤ - وأن نتصور ونتخيل بوضوح تام كيف نريد أن نكون.
فالأمر - إذن - يحتاج إلى تدريب ذهني ورياضة عقلية.
إذا فكرت بنفسك وكأنك صرت بالشكل المطلوب؛ فإن هذا التصور
يتحول إلى حقيقة بالتدريج. والواقع أن هذه هي الطريقة التي نكتسب بها العادات
الجديدة. وإلى هذا يشير الحديث الشريف القائل: "إنما
العلم بالتعلم والحلم بالتحلم" [رواه الدار
قطني، وهو ضعيف].
وقول الحسن رضي الله عنه: إذا لم تكن حليما فتحلم، وإذا لم
تكن عالما فتعلم، فقلما تشبه رجل بقوم إلا كان منهم.
يقول ابن سينا ( المتوفى عام ٤٢٨ هـ ) رحمه الله :
والأخلاق كلها الجميل منها والقبيح مكتسبة، ويمكن للإنسان
متى لم يكن له خُلق حاصل، أن يُحصله لنفسه، وأن ينتقل بإرادته إلى ضد ذلك الخلق. [علم الأخلاق ، مطبوع ضمن ( مجموعة الرسائل)، ص ۱۹۸].
ويقول الإمام الغزالي ( المتوفى عام ٥٠٥ هـ ) - رحمه الله -
عند حديثه عن ذكر الله له في كتابه « إحياء علوم الدين »، يقول ما معناه :
الذكر النافع هو ما كان مع حضور القلب (أي : مع التركيز، وهذا
ما عبرنا عنه آنفًا بقولنا: أن نتصور ونتخيل بوضوح تام كيف نريد أن نكون؛ فالأمر – إذن – يحتاج إلى
تدريب ذهني ورياضة عقلية)؛ فأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى.
وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله
عنه: (واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه).
وللذكر أول وآخر: فأوله يثمر الأنس بالله، واستشعار حبه سبحانه وتعالى، وآخره
يكون ثمرة للأنس والحب، وصادرا عنه. فإن الذاكر قد يكون - في بداية أمره - متكلفا
بصرف قلبه ولسانه عن الخواطر والوساوس إلى ذكر الله، فإن وفق للمداومة، أنس بربه،
وانغرس في قلبه حبه، ولا ينبغي أن يتعجب من هذا، فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره،
ومن أكثر ذكر شيء - وإن كان تكلفا - أحبه. ولا يصدر الأنس إلا من المداومة على
المكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصير التكلف طبعا. وقد يتكلف الإنسان تناول طعام
يستبشعه أولا، ويكابد أكله، ويواظب عليه فيصير موافقا لطبعه حتى لا يصبر عنه؛
فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف: هي النفس ما عودتها تتعود، أي: ما كلفتها أولا
يصير لها طبعا آخر. وهناك عدة طرق لتسريع عملية اكتساب العادات الإيجابية أهمها ما
يسمى: التوكيدات وهي الجمل التي :
(أ) ليس فيها أداة نفي.
(ب) ولا استقبال؛ بل تعبر عن الحاضر.
(جـ) وتستخدم ضمير المفرد المتكلم.
مثلا : إذا أراد شخص الإقلاع عن التدخين، فلا يقول: أنا لن
أدخن، أو أنا سوف أترك التدخين، أو أنا لا أحب التدخين ولكن ليقل: أنا أكره
التدخين التدخين يتلف صحتي ويدمر مالي. لقد أقلعت عن التدخين والحمد لله.
وهكذا تدخل الفكرة تدريجيا لتستقر في العقل الباطن وتوجه
السلوك بعد ذلك.
ويمكن تطبيق الطريقة نفسها على أي عادة يريد الفرد
اكتسابها، كممارسة الرياضة البدنية، أو إنقاص الوزن بتقليل كمية الطعام، فيقول
المرء مثلا: أنا أمارس الرياضة بشكل جيد. الرياضة تحسن صحتي وتزيد من نشاطي
الرياضة سبب لدفع المرض عني بإذن الله، أو : أنا آكل باعتدال، أنا أكره الإفراط في
الطعام. الدهون والحلوى تدمر صحتي وهكذا... ويفيد جدا أن نكتب هذه الجمل على ورقة
عدة مرات صباحا ومساءً مع الحماسة والاقتناع.
[تتمة هذه المقالة في الجزء الثاني]
جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
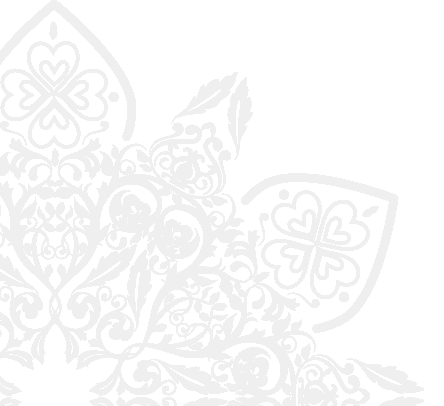




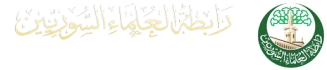
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول